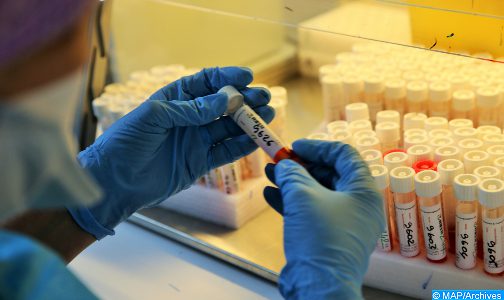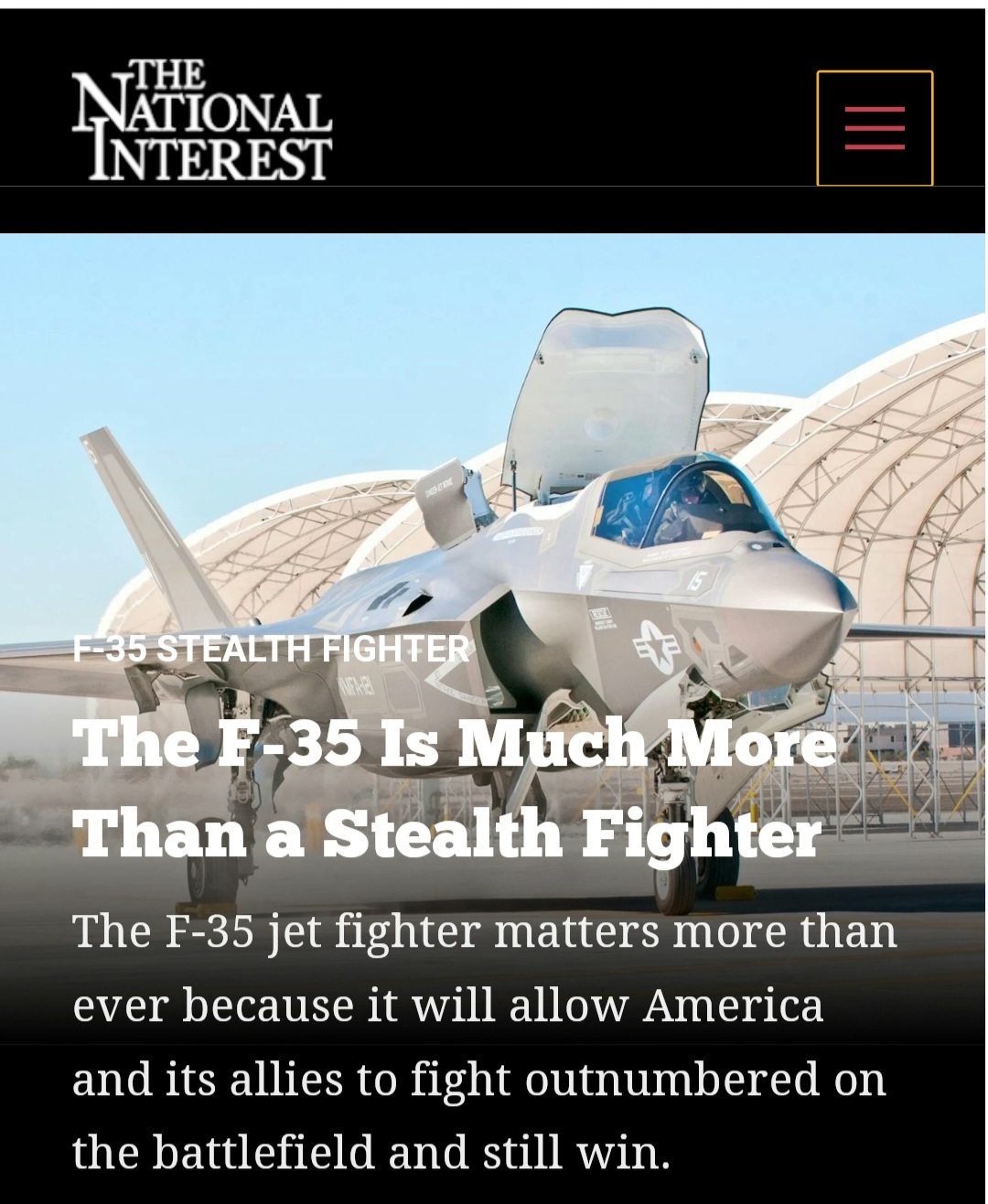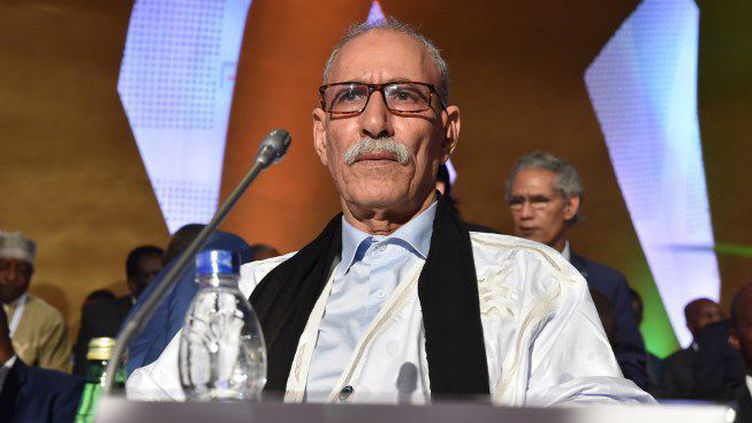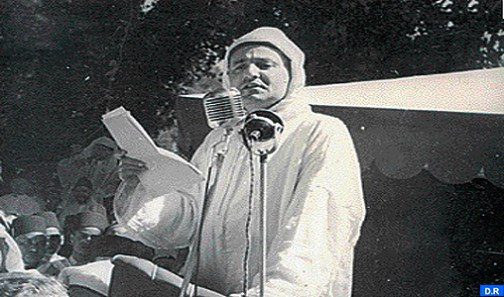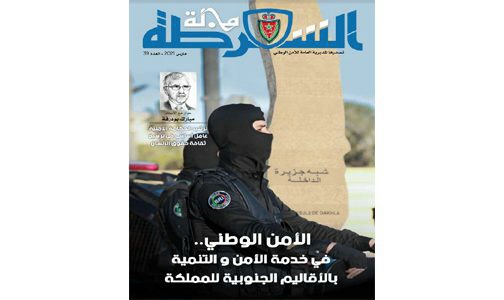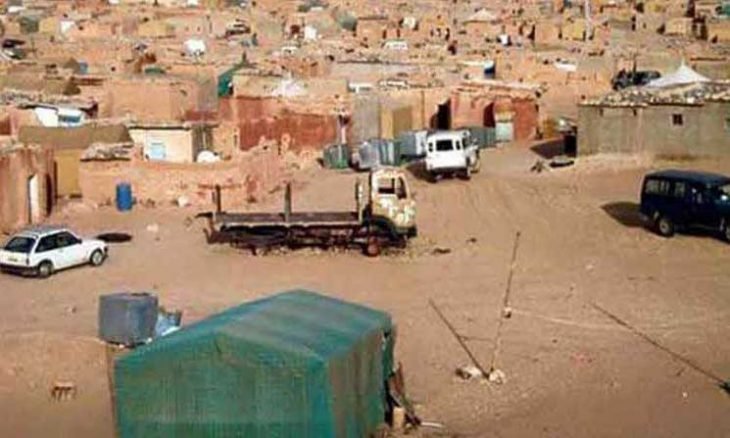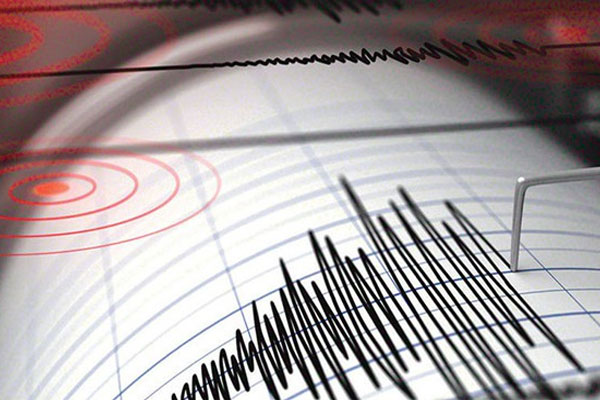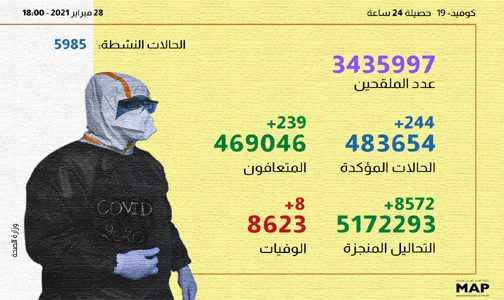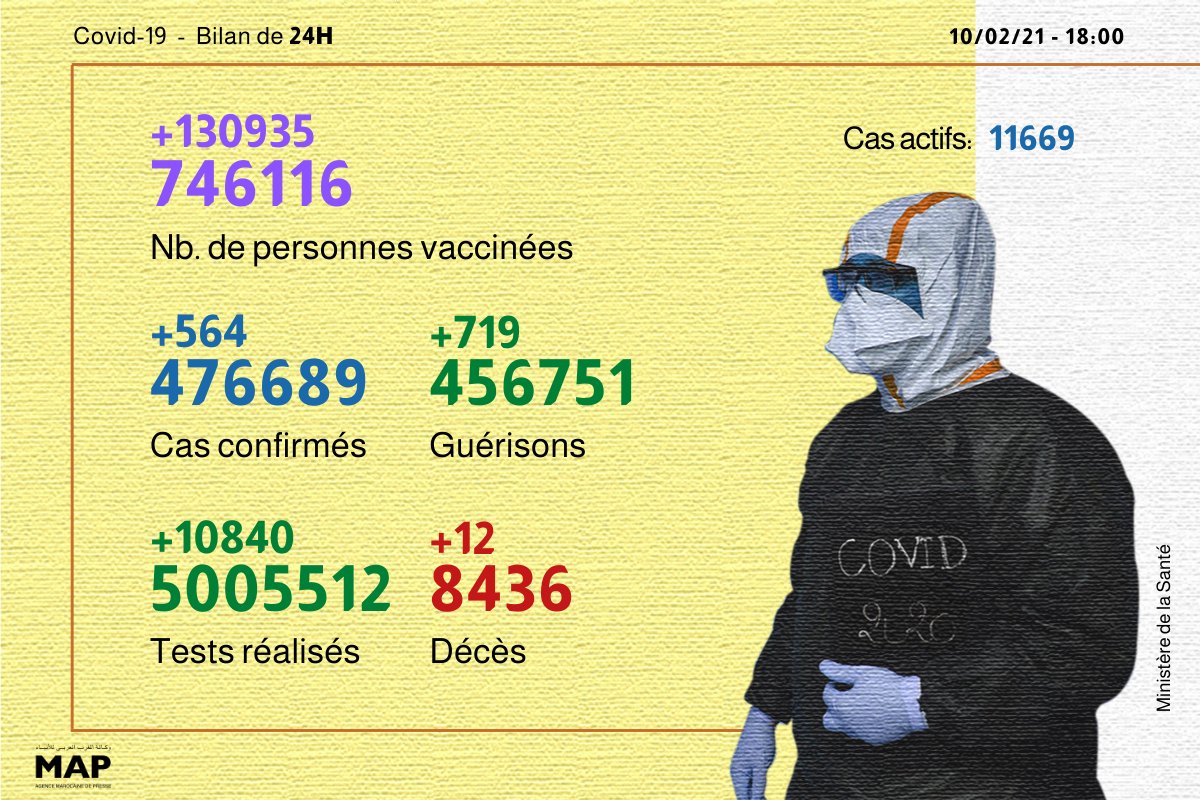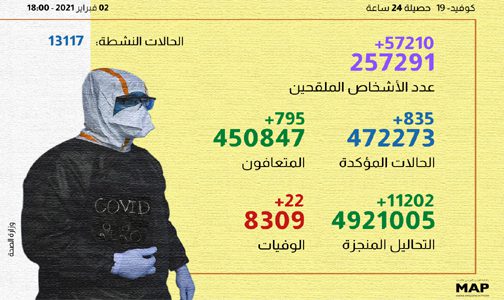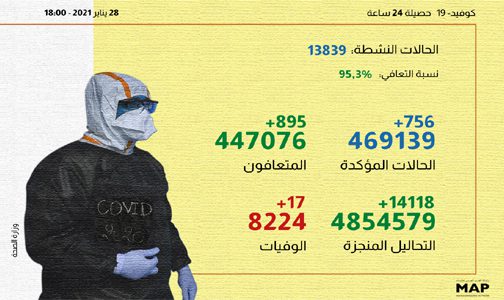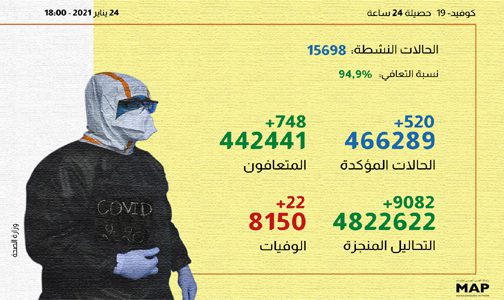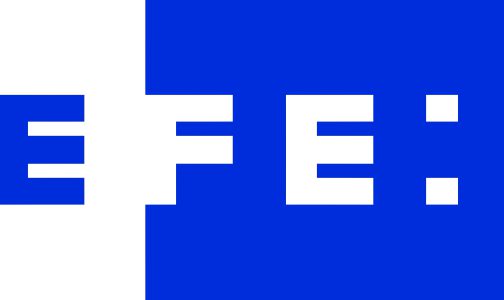بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية الغامبي حاملا رسالة خطية من رئيس جمهورية غامبيا إلى جلالة الملك
بقلم: عبدالحق الريكي، إطار بنكي
أحمد… صديق أيام النضال الطلابي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، مناضل ماركسي صلب، ينحدر من وسط قروي فقير لكن متأصل أبًا عن جد. عرفته في مدرجات وممرات وحلقات النقاش بالكلية. حركي إلى أبعد الحدود، هادئ الطبع، يثور كالبركان في لحظات النضال، خطيب ماهر، لا يقنط من المطالعة، مطالعة المجلات والجرائد والكتب، إذ لم يكن في ذاك الوقت وجود للإنترنيت والمواقع الالكترونية.
تفارقت بنا دروب الحياة بعد حصولنا على الشهادة الجامعية وكنت دائما معجبا بقدرته على الجمع ما بين اهتماماته النضالية وحركيته الدائمة (وأي نضال!!) وقدرته على استيعاب البرامج والمقررات ونجاحاته المميزة خلال كل مراحل الدراسة الجامعية.
تتبعت مساره السياسي لعدة عقود وكنت ألتقيه كل مرة تتاح لي فرصة زيارته في مدينته حيت يشتغل. هكذا علمت أنه التحق بحزب تقدمي لسنوات وساهم في معارك عديدة كماضل نقابي وحزبي، كما تبوأ مواقع المسؤولية الإدارية.
تغير كما تغير الكثيرون وكما يتغير العالم، لكنه بقي وفيا لقناعات محددة، الأولى استمراره في المطالعة إذ كلما وجدته وجدت معه كتابا أو جريدة أو مجلة، الثانية رفضه لكل الإغراءات والمساومات والثالثة والأهم، بحثه الدائم عن الحقيقة والطريقة المثلى للدفاع عن الطبقة العاملة والفلاحين الصغار في زمن مضى واليوم عن الفقراء والمستضعفين في الأرض.
التقيت أحمد خلال فصل الربيع الأخير وفاجئني بلحية تكسو وجهه لم أرى مثلها منذ سنوات الدراسة في الجامعة. فبادرته، بعد السلام والتحية، بالسؤال:
– هل عدت ماركسيا مرة ثانية صديقي أحمد أم ركبت موضة هذا الزمان، زمان المد الإسلامي وصعود الإسلاميين إلى الحكم؟
-صديقي العزيز علي، المسألة أعقد من هذا، سعيد أولا بلقياك، لأنني في حاجة لأخ مثلك يعرف قيمة الإصغاء والجدل البناء والأخوي، ستستغرب إن قلت لك أني، حيران، لقد كنت منهمكا في إعادة قراءة التراث الماركسي وفشل تجربة الاتحاد السوفياتي وفضاعات “بول بوت” وأزمة القيادة العمالية الاشتراكية بكل تلاوينها وإذا بي أجد نفسي منغمسا في أمهات الكتب حول الإسلام والسلفية والجهاد!!؟
– لم أعهد بك بهذا الحال يا أحمد!… كنت دائما ثاقب الفكر، نسبيا في تحليلك، لكن واضحا في فلسفتك ورآك.
– هي الحياة، هي سيرورة التطور والتغيير، أتذكر الفيلم الإيطالي الشهير “كم تحبينا” للمخرج إيطوري سكولا، الذي رأيناه ثلاث مرات في سنوات خلت والذي يقول فيه بطل الفيلم: “كنا نريد تغيير العالم… وإذا بالعالم يغيرنا!؟”.
– سأكون جد مسرور إذا قبلت مني دعوتك لغداء ونقاش هادئ على ضفاف النهر، لأني مقتنع أن لك الكثير مما تحكي وتعرف أحمد أنني أشتاق لسماع حكاياتك الواقعية والجميلة.
– مرحبا وألف مرحبا.
دام اللقاء مع الصديق أحمد ساعات طوال، تخللته سوى فترات أداءه فرائض الصلاة. قلت مع نفسي أحمد يصلي؟؟ يا مبدل الأحوال! ماذا وقع في كون الله حتى يصير أحمد الماركسي والاشتراكي لعقود عديدة قريبا من دين الإسلام، والإسلام السياسي. لنترك أحمد يحكي ولنصغ له ولحكايته التي هي تجربة للعديد من أمثاله في بلاد العرب والمسلمين في بدايات القرن الواحد والعشرين.
«… كانت البداية خلال نهاية شهر رمضان من السنة الماضية… أديت فريضة الصيام دون صلاة… لما عزمت الصلاة، فتحت المصحف الكريم وبدأت أحفض بعض السور القصيرة، لكن رغبتي كانت في قدرتي على قراءة القرآن كله. تعلم يا علي، أنني لا أستطيع قراءة شيئ لا أفهمه. فما كان مني إلا أن بدأت بقراءة القرآن باللغة العربية وترجمته باللغة الفرنسية. كان عمل مضني وشاق لكن شيق، ممتع ومفيد.
العجب العجاب أنني وجدت بخزانة كتبي، نسخة من القرآن باللغتين العربية والفرنسية، كان أبي – رحمه الله – أهداه لي منذ عشرات السنين. هل كان أبي يخمن أنه سيأتي يوما سأستعين به؟ العلم عند الله. لكن حضرني حينها الحديث الشريف “علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”، فدعوت له وهو الرجل الفقير المتواضع الذي كان لا يفارقه القرآن والذي لم يفرض أبدا رأيه على أولاده بل كان شعاره “الله يهدي من يشاء من عباده”.
ستقول يا علي… كيف طرأ أن اقتنعت بالصيام والصلاة؟ الحقيقة أن الأمر كان يخالجني هذه السنين الأخيرة، لقد أصبح للشأن الديني موقع ومعاقل كثيرة، إذ تتبعت كيف أصبح الدين الإسلامي مركز اهتمام أكبر المؤسسات الدولية من مصالح الاستخبارات إلى معاهد البحث ومراكز القرار. إن قمة هذا الاهتمام الدولي تجلى في المحاضرة التي ألقاها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، سنة 2009 في جامعة القاهرة بمصر حول العالم الإسلامي، والتي كانت علامة من علامات الساعة حول التغييرات المستقبلية بالعالمين العربي والإسلامي والدولي.
إن كل متتبع للخطاب الهام لباراك أوباما، الذي تطلب ساعات وساعات لإعداده نظرا لحساسية الموضوع وفريق من المتخصصين والباحثين في صبر كل فقرة من فقراته، سيلاحظ كيف تم ربط المسائل التي تناولها الخطاب حين ألح على واجب مجابهة “التطرف العنيف بكافة أشكاله” مقرونا بكون “أمريكا ليست ولن تكون أبدا في حالة حرب مع الإسلام” إلى حين تناول المسألة الشائكة المتعلقة حينها بقضية “الديمقراطية”، منعرجا على “موضوع الحرية الدينية” و”حقوق المرأة”.
إن كل هذه القضايا، الإسلام، الديمقراطية، الحرية الدينية وحقوق المرأة توجد اليوم في قلب الصراع داخل المجتمعات الإسلامية والعربية. ألم أقل لك صديقي علي، أنهم، الغرب “الإمبريالي” في لغتنا القديمة، قوى الاستكبار العظمى في لغتنا الجديدة، سبقونا أميالا لفهم واقعنا وما يمور من تحولات في مجتمعاتنا؟
بدأت في البداية أبحث عن أحسن الطرق لفهم و”مواجهة” الفكر “السلفي الجهادي”. فكان الطريق معبدا نحو المفكرين المتنورين المسلمين والعجم منهم والذين تخصصوا في الإسلام والفكر الإسلامي والحركات الإسلامية. فبدأت بكتاب “السيرة النبوية” و”نزول القرآن” ل”محمود حسين” باللغتين الفرنسية وعرجت من بعد على كتب نبيل فياض، أركون، عبدالكريم خليل وعبدالمجيد الشرفي وغيرهم، وأنا أنغمس في لذة ومتعة وفائدة القراءة وجدتني أغوص في كتب التفاسير للجلالين وابن كثير منعرجا على “معالم من الطريق” للسيد قطب و”الإسلام وأصول الحكم” للشيخ علي عبدالرزاق وصولا عند ابن تيمية وكيف لا!!، وكتب ومقالات عديدة بفضل هذا العالم الافتراضي المدهش وأجمل وأكبر وأغنى مكتبة في العالم، الإنترنيت وغوغل وإمكانية تنزيل أمهات الكتب.
سوف لن تصدقني إن قلت لك أنه بعد شهور وشهور من قراءة أمهات الكتب في الميدان، وجدتني منغمس في قراءة ومطالعة آدبيات الإسلام القديم والحديث. كنت أبحث عن طريق لمواجهة الفكر الإسلامي “المتحجر” وإذا به أجدني أنغمس في هذا الفكر وأقتنع رويدا رويدا به. وجدتني، صديقي علي، في لحظات تفكير أحدث نفسي، هل ما يقع لي من نتاج الضغط المجتمعي الذي غزاه الفكر والممارسة الإسلامية، هل هو ناتج عن سني الذي تعدى مرحلة الشباب منذ أمد بعيد؟ هل هو نتاج فشل يوطوبيا ماركس ونهاية القيادة الاشتراكية؟ أم هي تلك الرغبة الجامحة في البحث عن الحقائق والتعامل النسبي مع الوقائع وانبهاري بدفاع “الإسلاميين” عن الفقراء والمستضعفين في الأرض ورغبتي الدائمة في الانخراط في كل معركة من أجل الحق والكرامة والعدل؟
لقد خضت لوحدي ما بين دفتي الكتب والمقالات حوارات حول “التأخر التاريخي” لأمتنا، حول مفهو السلفية، حول بدايات الصراع بين العقل والنقل، ما بين المعتزلة والحنابلة، هل الإنسان مخير أم مسير، هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق، فاكتشفت أن السلف كانت له باتجاهاته المختلفة اجتهادات قيمة حول كل هذه القضايا وأنه أصبح اليوم من شبه المستحيلات الغوص في هذه القضايا دون تجريح و”تكفير” من كل الأطراف “العلمانية” و”الحداثية” من جهة و”الإسلاموية” من جهة أخرى. لكن، صديقي علي، ما حز في قلبي هو “أمية” شرائح عديدة من “المثقفين” و”السياسيين” لهذه الأمور التي تشكل “عقلنا الجماعي” و”نفسية أمتنا”، كره من كره وأحب من أحب.
أعتقد أن البدايات لفهم “ذاتنا” تبدأ من هنا، وهذا يحيلني على الكتاب القيم للأستاذ خالد محمد خالد “من هنا نبدأ” والذي تلاه رد العلامة محمد الغزالي في كتابه القيم أيضا “من هنا نعلم” – رحمهم الله -. كتب قيمة صدرت سنة 1950 من القرن الماضي وكأنها تتحدث عن أيامنا هاته. هل لم نتقدم كل هذا الوقت!!؟؟
ولإذكاء شهيتك، أخي علي، لقراءة ومطالعة تلك الكتب، هاهنا بعض الفقرات من كل كتاب، في البداية مع فقرة من الصفحات الأولى ل”من هنا نبدأ” حيث يحث خالد محمد خالد متصفح الكتاب على ما يلي “ولست أرجو من الذين سيقرأونه سوى أن يؤمنوا بحرية القول وحرية الفكر، وأن يقرأوا بعقولهم، لا بعواطفهم، وألا يصرفهم الرأي المخالف عن تدبره وبحثه في هدوء. فعسى أن يكون الحق ويكون الصواب”. وفي مقدمة كتاب “من هنا نعلم” التي كتبها فضيلة الشيخ صالح العشماوي – رحمه الله – نقرأ ما يلي: “وها هو ذا فضيلة الشيخ محمد الغزالي يقدم كتاب “من هنا نعلم” ليدحض به الشبهات التي أثارها صاحب كتاب “من هنا نبدأ” ويميط اللثام عن أخطاء كبيرة وقع فيها، ويظهر الإسلام في نقائه وصفائه، على أن الدين القيم المنقذ للحضارة ولمقوماتها النبيلة… وكم كان موفقا كل التوفيق حين كتب مبينا علاقة الدين بالدولة وأنهما وحدة لا تقبل التجزئة، وأن كل محاولة للفصل بينهما إنما هو إفساد للإسلام وعدوان عليه من حيث هو عقيدة وشريعة على السواء”. كأنني حاضر في نقاش ما بين المعتزلة والحنابلة في القرون الأولى للهجرة، وهذا نقاش عرفته الساحة المصرية في الخمسينيات من القرن الماضي وهو ما زال إلى يومنا هذا نقاش في بلدان عربية من ضمنها بلدنا، المغرب. فمتى نتقدم في النقاش ونتوافق على أمهات القضايا؟؟
كانت البدايات صعبة للغاية… كان “الشيطان” والوسواس حاضرين دائما وأبدا، يصعب أن تمحو ثلاث عقود من القناعة كون “الدين أفيون الشعوب”. رغم أنك، أخي علي، تعرف جيدا أني كنت ليبراليا في مواقفي من الإسلام ومحترما لشعائر عائلتي وأهلي.
تتذكر، صديقي علي، أنني لم أكن مقتنعا بما كان بعض الرفاق يطلبونه حول ضرورة اقناع أفراد عائلتنا بمبادئ الماركسية. أما زلت تتذكر الموقف الحرج الذي وقع فيه صديقنا مصطفى حين عاد خلال فصل الصيف إلى أهله في قريته الصغيرة، بعد سنته الدراسية الأولى بالجامعة والتي كان له خلالها حديثا مطولا مع أبيه الرجل المتدين الموقر. أتتذكر أن مصطفى حاول أن يقنع أباه بأفكار ماركس ولينين وبنظرية دارويين وعلم النفس لفرويد، وكيف كاد أبا مصطفى أن يهشم رأسه بعصاه، ناعتا ولده بالكافر.
لم ينسى مصطفى طول حياته ما وقع له في مرحلة الشباب الثائر وكانت الفرصة مواتية لنا نحن رفاقه بعض لحظات من الضحك محاولة استيعاب ما وقع لمصطفى ولكن أساسا لفتح نقاش عميق حول واقع المجتمع الإسلامي وانغراس الدين فيه وتعامل أي حركة سياسة مع هذا الواقع. في الحقيقة كان النقاش محدودا في مجالات ضيقة ولم ينتشر على صعيد الحركات الماركسية والاشتراكية نظرا لأولويات المرحلة.
أتتذكر، يا علي، أننا كنا معجبين بالمجاهد والثائر محمد بن عبدالكريم الخطابي وكنا نناقش خططه الحربية وكيف استفاذ منها القائد الشيوعي الفيتنامي، هوشي منه، والثائر العالمي إرنستو شي كيفارا، وكيف استطاع ابن عبدالكريم الخطابي تجنيد الفلاحين الفقراء ومواجهة الاستعمار الإسباني ووضع أسس دولة حديثة. لكن أهم النقاش غاب عنا في تلك الفترة إذ كنا نتحاشى الحديث حوله وهو المتعلق ب”وهابية” المجاهد ابن عبدالكريم الخطابي، ودراسته بالقرويين وكونه كان قبل ذالك فقيها وقاضيا وأن الدعامة الأساسية لتوحيد ساكنة الريف والقبائل المجاورة حوله هي “لعنة الله على الكافرين” وما كان لدور الدين الإسلامي من أهمية في كل مراحل ثورة الريف.
أعتقد أنه لم تكن الشجاعة من جهة والتمكن والدراية بالموضوع من جهة أخرى لمناقشة موضوع حساس وأساسي بالنسبة لكل الحركات الماركسية والاشتراكية بالعالم العربي والإسلامي. خاصة أن تجربة الحزب الشيوعي السوداني كانت نموذجية في هذا الجانب. المشكل هو كون هذه الحركات إلى يومنا هذا، رغم مجهودات محدودة، غائبة عن أهم نقاش في الساحة: ما هو الإسلام وما دوره في تشكيلة المجتمع؟ يِألمني حين أرى أن القوة العالمية العظمى، وعت منذ زمن بعيد بهذا المعطى الاستراتيجي ودوره في الصراع العالمي والجهوي والمحلي وكيف أنها سخرت كل الإمكانيات لمعرفة أدق تفاصيله وأهم الطرق للتعامل معه. تلك حكاية أخرى…
أما الشيق في المسألة هو تغير نظرتي للحياة وتغيير تعامل محيطي معي من عائلتي الصغيرة وأصدقاء العمل والمحطين بي. لقد أصبحت بلحيتي والتزامي بالصلوات الخمس بما في ذلك صلاة الفجر والنوافل وتلاوة القرآن “فقيها” عند البعض و”خوانجي” عند البعض الآخر، بعد أن كنت مناضلا اشتراكيا. فكان أبنائي ينتظرون مني كل لحظة “فرض” عليهم الصلاة وابنتي “الحجاب”. أما في الصباحات حين غذونا إلى المدرسة بالسيارة، كانت ابنتي تطلب مني إن كان ممكنا تغيير قناة الراديو من “إذاعة القرآن الكريم” إلى إذاعة “مومو” و”هيت راديو”!! لم أكن أمانع في ذلك ووجدتني أتبع منهاج أبي –رحمة الله عليه – وأقول مع القرآن الكريم في سورة السجدة “ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها”.
لقد كانت هذه المرحلة الجديدة غنية على المستوى الشخصي إذ قوت إيماني وجعلتني أعيش مع أشياء الحياة بنكهة أخرى، أصبحت للحياة وللموت طعم جديد، صارت حياتي جد منظمة بفضل الصلوات والصيام والرياضة واتسعت فترات القراءة والمطالعة بعد أن ابتعدت عن ساعات السمر الليلي.
لقد منحني قراءة القرآن الكريم لأول مرة ولمرات عديدة القدرة على الغوص في الكتابة باللغة العربية وأنت تعلم، علي، أنني قليلا ما كنت أقدم على الكتابة بلغة الضاد وأن الفرنسية كانت ومازالت اللغة الأكثر استعمالا لدي.
بلحيتي أصبحت أمام أصدقائي والذين ألتقيهم “الحاج” أحمد رغم أنك تعلم أنني لم أزر بعد ذلك المقام الكريم. كم من مرة تأملت منظري وشكلي الجديدين أمام المرآة. أصبحت شخصا آخر.
أتعرف ماذا وقع لي في أحد الأيام حين ذهبت إلى ميكانيكي شاب لأصلح عطب في سيارتي. وجدته يشتغل على أنغام موسيقى الراي ولما اتفقنا على إصلاحه سيارتي والجلوس في ورشه إلى حين انتهائه من عمله، إذ به ينحو إلى جهة جهاز الراديو كاسيط ويغير قرص الراي بقرص لآيات الذكر الحكيم. المشكلة هي أن جهازه لم يكن ذات جودة عالية ولم نكن نسمع جيدا المقرئ وهو يتلو ما تيسر من القرآن الكريم.
أما أصدقائي الأوروبيين فكنت أنتظر منهم موقف التعجب من قناعاتي الجديدة، والتزامي بالصلاة والابتعاد عن ما نها عنه الدين الإسلامي الحنيف. ما وقع هو العكس، إذ زاد احترامهم لي وتيقنت حينها أنهم رغم ادعائي العلمانية وتوهمي بأن هذا يقربني منهم، كان العكس هو الصحيح، إذ لم يكونوا في عامتهم يفهمون كوني مسلم وأبتعد عن ممارسات الأغلبية من أمتي. تيقنت حينها ما لدين الإسلام من وقع على عقول ومخيلة وتفكير وهواجس الأمم الأخرى وكيف أصبح الدين الإسلامي يخيم على كل الفضاءات والاهتمامات السياسية والثقافية والإعلامية.
تعرف علي… في البدايات لم أكن ملما بكل تفاصيل الفرائض لكني كنت أتعامل وفق ما ذكر في الحديث الشريف عن ابن كثير«كما قال ذلك الأعرابي: أما أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبي ”حولها ندندن”».
كما لا أخفي عنك صديقي علي، أن قراءة الكتب حول بدايات الرسالة المحمدية جعلتني ألتقي بأصحاب رسول الله، رجال من طراز ومعدن خاص، ولا سيما الفقراء منهم والعبيد والباحثين عن الحقيقة كأمثال مصعب بن عمير أول سفير إلى المدينة، بلال بن رباح الساخر من الأهوال، العبد، وأول مؤذن والقاهر للكفار بقولته الشهيرة “أَحَدٌ.. أَحَدٌ..”، وخبيب بن عدي بطل.. فوق الصليب، وعمار بن ياسر من ضعفاء مكة وفقرائها، وأبو ذر الغفاري زعيم المعارضة وعدو الثروات والذي يمشي وحده.. ويموت وحده.. ويبعث وحده.. وسلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة صاحب فكرة “الخندق” والذي كان فارسيا مجوسيا ومن بعد نصرانيا ومات مسلما صحابيا جليلا وخالد بن الوليد الذي لا ينام ولا يترك أحدا ينام، الفاتك بالمسلمين يوم أحد والفاتك بأعداء الإسلام بقية الأيام..!! وغيرهم كثير رضوان الله عليهم. أما عن دار الأرقم فالحديث يطول. (كل الأفكار مأخوذة من كتاب خالد محمد خالد – رحمه الله – حول “رجال حول الرسول “).
في أحد الأيام الأولى من التزامي بالدين وأنا خارج من المسجد وجدتني في حلقة منظمة من طرف تيار إسلامي (حاولت معرفة أي فصيل هو لكن جعبتي المعرفية آنذاك لم تكن كافية لذالك) للتضامن مع أهل غزة وفلسطين وأنا أردد مع الجماعة “لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد ومن أجلها نلقى وجه الله”. أتذكر أخي علي، أن هذه الازمة الإسلامية كان يعجبنا سماعها لنغمتها الجميلة وكلماتها القوية النافذة في الزمن الطلابي وكنا كلما سمعناها عرفنا أن إنزالا قويا للتيار الإسلامي قد بدأ وأنه علينا الاستعداد والتعبئة لكل الاحتمالات. ستقول صديقي علي، سبحان مبدل الأحول. نعم، سبحان مبدل الأحوال.
جاءت الانتخابات العامة وكما تعرف يا أخي علي، قناعتي هي ضرورة المساهمة المواطنة في العملية الانتخابية رغم كل الشوائب والنواقص التي يمكن تسجيلها، فكانت لحظة حقيقة، إنها لحظة تفرض عليك منح صوتك لطرف واحد لا غير رغم أن بعض الأحيان يكون تعاطف الإنسان مع أكثر من حزب أو مرشح. داخل المعزل كان تردد داخلي حسم في الأخير باعطاء صوتي للتيار الإسلامي. وتبين لي بعد صدور النتائج أن فئات واسعة من المواطنين حدوا نفس منطقي رغم ترددهم ما بين أحزاب ألفوا التصويت لمرشحيها في سنوات خلت ولكن يئسوا منها ومن قياداتها. إن شيء ما عظيم يمور في أحشاء مجتمعنا أتمنى صادقا أن يكون محط نقاش وبحث من طرف الباحثين والمهتمين.
مرة كنت مع عائلتي بأحد المتاجر التجارية الكبرى فقمت لأداء فريضة الصلاة، وبعد الركعة الأولى وجدت نفسي أصلي بحذائي، فأوقفت الصلاة ونظرت يمنة ويسرة إن كان أحدا يتأمل منظري، لم أكن أعلم إن كان مباحا أم لا الصلاة بالحذاء، فلما خلعت حذائي وأقبلت على الصلاة إذ بمنظفة تنبهني إلى وجود مكان للصلاة قريب، فقصدته.
الحكاية أنني التقيت في باب المسجد شخصان يهمان بالصلاة فطلبا مني نظرا للحيتي وسني أن أئمهم في صلاة الجماعة، كان الموقف صعبا للغاية، هم يلحون وأنا في ورطة من أمري لا علم لي بكيف ومتى وحتى. فصرحت لهم أنني جديد على شعائر الدين، فقام أحدهم بإمامتنا وكان مضطلعا بكل أمورها وحين انتهينا كان لي حديث ودي معه علمت أنه من بلد عربي شقيق وأنه ما شاء الله متمكن من أمور الدين، حياني على صراحتي وتمنى لي التوفيق والسداد في مسيرتي وحياتي.
أما على المستوى السياسي فكان الوقع قويا والحيرة أكبر ما بين ما تبقى من مواقفي الماركسية والاشتراكية وصداقات أصدقائي في المعسكر “العلماني الحداثي” واقترابي من الحركة الإسلامية. لا أخفي عنك، صديقي علي، أنني ما زلت في حيرة من أمري. كيف أوفق ما بين أشياء تبدو لي متناقضة ومتعارضة في شعاراتها الكبرى ك”الإسلام هو الحل” و”الديمقراطية هو الحل” وما بين “الدولة الدينية” والدولة المدنية” وهل الحركات الإسلامية “رجعية” وليبرالية ورأسمالية؟ وما موقع حقوق المستضعفين في أطروحاتها وسياساتها وشعارتها. وهل هي ديمقراطية أم كما يقال تريد سوى استعمال آليات الديمقراطية للانقضاض على الدولة والمجتمع ب”تدرج” و”تقية”.
لكن ما أصبحت مقتنعا به هو كون الحركات الإسلامية أصبحت اليوم ولفترة زمنية طويلة المعبر الرئيسي عن طموحات فئات واسعة من المجتمع خاصة الفئات المتوسطة والمستضعفين منهم. حاولت إيجاد توافقات ما بين مبادئي القديمة وتوجهاتي الجديدة وما زلت “هائم” ليوم الناس هذا. لكني اقتنعت أن على كل الحركات التي تدافع من مواقع مختلفة عن “إبعاد الدين عن السياسة” كانت اشتراكية، ليبرالية، حداثية وعلمانية أن تقف لحظة للتأمل في الوضع الجديد وإعمال العقل والتفكير والإبداع في اللحظة التاريخية الجديدة المتسمة بغلبة الفكر الديني على العديد من مناحي الدنيا والسياسة والمجتمع…».
هذا طيف قليل استطاعت ذاكرتي أن تلتقطه من الحديث الشيق لصديقي أحمد. لم تتح الفرصة لمناقشته حول قضايا عامة وخاصة تهم مسار حياته الجديدة، لكن وعدته أنني سأزوره خلال فصل الصيف لمدة أسبوع حتى نخوض في هذا النقاش الشيق والمفيد واعدا إياه أنني سأغوص أيضا في أمهات الكتب الذي تحدث عنها حتى يكون النقاش متكافئا وبناء. طلبت منه في الأخير وهو يعرف رغبتي الجامحة في إشراك الآخرين في النقاش إن كان ممكنا أن يسمح لي بكتابة مقال صحفي حول هذا الموضوع. فابتسم أحمد، وقال لي تصرف يا صديقي، إني أثق في قدرتك على تقديم آرائي في قالب “موضوعي” ومفيد.
توادعنا بحرارة، صديقي أحمد وأنا الذي تذكرت حينها جملة من قصة الكاتب المغربي ادريس الخوري “مليكة… البحر يقترب، وعباس يختلط عليه الأمر” وذلك لكوني أعيش نفس التناقضات لتي حدثني عنها “الرفيق” أ
الرباط، غشت 2012